في العنصرية الثقافية: نظريات ومؤامرات وآداب
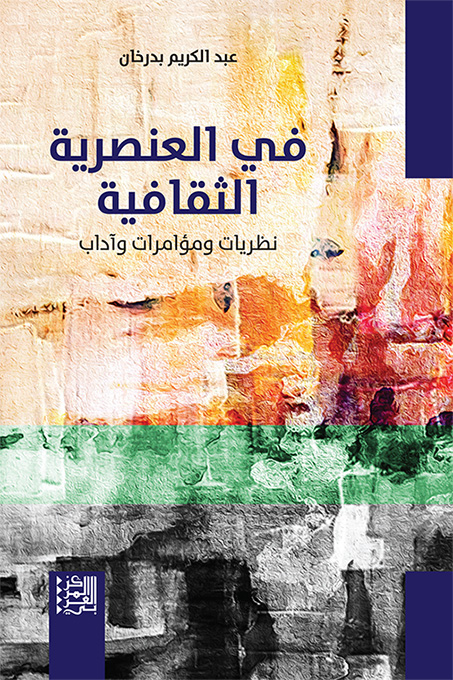
عنوان الكتاب:في العنصرية الثقافية: نظريات ومؤامرات وآداب.
المؤلف: عبد الكريم بدرخان.
الناشر: الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
سنة النشر: 2024.
عدد الصفحات: 264.
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب
في العنصرية الثقافية: نظريات ومؤامرات وآداب لعبد الكريم بدرخان. يقع الكتاب في 264 صفحة. ويتناول في فصوله السبعة معاني العنصرية وأنواعها وفلسفاتها وتطورها مع التغيرات السياسية في ظل العولمة، مع التركيز على التغييرات التي طرأت في العقود الثلاثة الأخيرة. كما يتناول أفكار ونظريات شهيرة لشخصيات أدبية مثل صامويل هنتنغتون وفرانسيس فوكوياما، ويركز على الأدبيات والنظريات التي تدعم الفكر الإسلاموفوبي.
ثمة إشكالية تتمثل في تحول العنصرية من "العنصرية البيولوجية" إلى "العنصرية الثقافية"، حيث تقوم هذه الأخيرة على تقسيم الشعوب ثقافيًا وتحديد صفات ثابتة لثقافة شعب أو جماعة معينة. وقد سقطت النظرية العرقية مع سقوط النظام النازي وتأسيس الأمم المتحدة، لكن موجة النيوليبرالية في الثمانينيات ونهاية الحرب الباردة أدتا إلى ظهور نظريات تقسّم العالم حضاريًا وتبرّر التفاوت الاقتصادي باختلاف الثقافات. وقد أكملت أحداث 11 سبتمبر وما تلاها من غزو أميركي لأفغانستان والعراق، وانتعاش خطابات ونظريات وآداب تضع الإسلام في موضع العدو للغرب، المشهدَ مع الهجرة الواسعة إلى أوروبا في عامَي 2014 و2015، مما أعاد العنصرية الثقافية إلى الواجهة.
ينتقد الكتاب النظريات والطروحات العنصرية، موضحًا لا علميتها وانحيازها، كما يعرف بالثقافة ويناقش علاقتها بالديمقراطية، ويوضح أن العنصرية قديمة قدم الجماعات البشرية لكنها تتطور مع المجتمعات، مشيرًا إلى أن العنصرية البيولوجية كانت أخطر مراحلها حيث كانت المحرقة النازية أكبر جرائمها.
إن النظريات السياسية التي تعطي الثقافة أهمية يجب أن تُسأل: هل تحدد هذه النظريات صفات جوهرانية ثابتة لكل ثقافة وتعممها على معظم أبناء الثقافة؟ وهل تفسر الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتلك الصفات؟ يعرض الكتاب الانتقادات الموجهة إلى النظريات الثقافوية التي تفسر تقدم الدول وتأخرها أو غناها وفقرها على أساس ثقافاتها. ويبرز رفض مقولة "الاستثناء العربي" أو "الاستثناء الإسلامي" في مسألة الانتقال الديمقراطي، ويشير إلى أن نظريات مثل "نظريات التحديث" و"صدام الحضارات" تهدف إلى تبرير الدعم الغربي لأنظمة استبدادية أو توسع الإمبراطورية الأميركية. ينتقد الكتاب أيضًا نظريات المؤامرة التي بلغت أقصى درجات العنصرية والخطورة، مثل نظرية "الاستبدال العظيم" التي ترى في هجرة المسلمين إلى أوروبا مؤامرة تهدف إلى أسلمة أوروبا وإبادة أهلها البيض.
ثمة دور للأدب في تشويه صورة "غير الأوروبيين" وتعزيز مخاوف الناس من هجرتهم، مثال ذلك روايات "معسكر القديسين" لجان راسبيل و"استسلام" لميشيل ويلبيك. فقد ساهمت هذه الروايات في تكوين فكر اليمين المتطرف وزعماء اليمين الشعبوي. وقد قدمت الروايات التي كُتِبَت بعد 11 سبتمبر الإرهاب بوصفه تنفيذًا لنصوص دينية، مما يعزز خطاب الإسلاموفوبيا.
يؤكد الكتاب على ضرورة نقد مقولات العنصرية الثقافية وتبيان خطورتها وكيفية استخدامها ولمصلحة من، خاصة في الدول العربية التي تُستخدم فيها هذه المقولات لتبرير قمع المعارضين. كما يوضح أن استخدام زعماء اليمين الشعبوي في الغرب لشعارات التمييز العنصري هو لإيقاظ مشاعر الكراهية وكسب الأصوات الانتخابية.
ويُختتم الكتاب بالتأكيد على ضرورة بناء مؤسسات تقوم بمهمة نقد العنصرية الثقافية وتعزيز التعددية الثقافية، مع رفض مقولات "النقاء" و"التفوُّق الثقافي"، مؤكدًا أن الهوية الفردية والجماعية مركّبة وهجينة ولا تقبل الوحدانية. ومن المهم نقد مقولات العنصرية الثقافية نظرًا لتأثيرها الكبير في الخطاب السياسي والاجتماعي، وتأكيدها على ضرورة احترام التعددية الثقافية والديمقراطية.
في مستوصف الفلسفة: محاولة رسم معالم علاج بديل
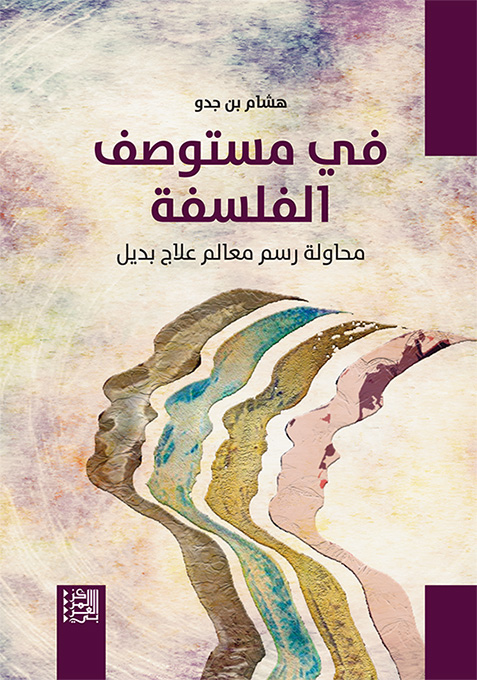
عنوان الكتاب:في مستوصف الفلسفة: محاولة رسم معالم علاج بديل.
المؤلف: هشام بن جدو.
الناشر: الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
سنة النشر: 2023.
عدد الصفحات: 336.
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب
في مستوصف الفلسفة: محاولة رسم معالم علاج بديل للباحث هشام بن جدّو. يقع الكتاب في 336 صفحة، ويشمل ببليوغرافيا وفهرسًا عامًا. ويتناول في أربعة فصول موضوعًا جديدًا وجديًا يتمحور حول ضرورة إعادة النظر في التراث العلمي النفسي والعقلي الغربي، ونقد بعض المسلمات والنظريات المعتمدة فيه. ويدعو الأمة العربية إلى النهوض بهذا التراث على أسس مختلفة عن الأسس الغربية المستهلكة، نظرًا إلى ما يحتويه التراث العربي من كنوز معرفية في هذا المجال.
يقول المؤلف، الذي كان مهتمًا بمشكلة "سؤال القيمة" ونقد آليات التشخيص في التحليل النفسي، إن فكرته نشأت بعد أن لفتت انتباهه طريقة تقديم غي فليكس ديبورتاي، أستاذ التحليل النفسي في قسم الفلسفة بجامعة السوربون، لأفكار سيغموند فرويد وجاك لاكان على أنها حقائق علمية. ويرى بن جدّو أن التحليل النفسي ليس مجرد منهج للعلاج، بل هو فلسفة متكاملة تحدد المعياري والمعرفي، وتؤثر في التربية والممارسات الاجتماعية، خصوصًا فيما يتعلق بالدين. وعبر استقصائه لتراث التحليل النفسي، لاحظ وجود فروق جوهرية في تحديد مفهوم الطبيعة الإنسانية بين فرويد، ويونغ، وينيكوت، وبنيامين ستورا، وميلاني كلاين، وآخرين، على الرغم من محاولات بعضهم تبرير منطلقات التحليل النفسي كما حددها فرويد.
ويطرح الكتاب تساؤلات حول بديهيات فلسفات العلاج القائمة في التحليل النفسي وطب الأمراض العقلية، ويبحث في التخبط المعرفي والمنهجي الذي نشهده في تباين فلسفات العلاج. ويختبر مدى علاجي لأفكار يعتبرها المحللون النفسيون وأطباء الأمراض العقلية "مصدر" الأمراض النفسية والعقلية، مثل الإيمان، والفن، والحياء، والحب، مؤكدًا على أن هذه الأمور يمكن أن تساهم في تحقيق الصحة النفسية.
كما يبحث الكتاب في تطور دربة العلاج الفلسفي الذي يقوم على رعاية كفايتَي التعقّل والتخلّق، ويعيد قراءة أرشيف الفلسفة قراءة علاجية. ويتناول التساؤلات حول دور النص الفلسفي في بلورة دربة العلاج الفلسفي، وكيفية فهم الفلاسفة للطبيعة الإنسانية، وأهم التقنيات التي استخدموها لإثراء فلسفات العلاج. ويُعقد الأمل على إيجاد المختصين في الطب النفسي والعقلي في العالم العربي ما يساعدهم على تطوير أساليب العلاج البديلة، وتجاوز أزمة العلاج النفسي والعقلي في العالم الغربي. مع الإشارة إلى ضرورة انفتاح التراث الاستشفائي الفلسفي لرصد الأبعاد الزمنية للإنسان، وفهم تطلعاته وتطوير أساليب العلاج من خلال تجارب الفلاسفة.
يدافع الفصل الأول عن مشروعية "الطب الفلسفي" في خريطة الاستشفاء النفسي والعقلي، ويستعرض نشأته في مختلف الثقافات. ويعرض الفصل الثاني ثلاثة نماذج لممارسة دربة العلاج الفلسفي، تشمل مشروعَي أرسطو وكارل ياسبرس، ومرجعية ميشيل فوكو في نقد التحليل النفسي. ويتناول الفصل الثالث الجهد الأرسطي في مصالحة الحكمتين العملية والنظرية، ويسلط الضوء على دور الأخلاق في العلاج. أما الفصل الرابع فيُناقش تقنيات العلاج الصوفي، وأهميتها في تحقيق الراحة النفسية، ويستعرض فلسفة الصمت وغيرها من تقنيات العلاج الروحاني.
يُمكن القول إن الكتاب يسعى إلى تقديم بدائل علاجية جديدة تعتمد على فلسفات مختلفة، ويحث على استغلال التراث الفلسفي العربي لإيجاد حلول مبتكرة للصحة النفسية والعقلية.
ماكس فيبر: الشغف بالتفكير ليواخيم رادكاو
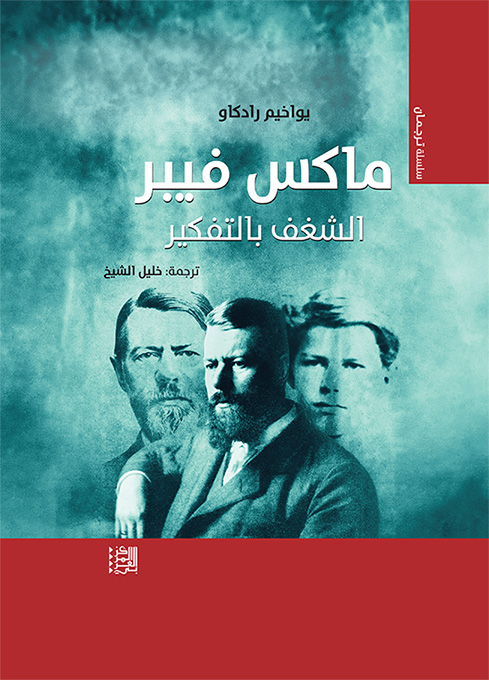
عنوان الكتاب:ماكس فيبر: الشغف بالتفكير.
المؤلف: يواخيم رادكاو.
المترجم: خليل الشيخ.
الناشر: الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
سنة النشر: 2024.
عدد الصفحات: 1376.
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ضمن سلسلة "ترجمان"، كتاب ماكس فيبر: الشغف بالتفكير الذي ألّفه يواخيم رادكاو. يتناول الكتاب حياة عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، وهو سيرة موسوعية تتألف من 22 فصلًا موزعة على ثلاثة أقسام. يركز الكتاب على طفولة فيبر وتأثير أسرته فيه، خاصة والدته وشقيقه ألفرد. كما يناقش شخصية فيبر الموسوعية، التي برعت في العديد من العلوم، ومرضه المبكر الذي لم يمنعه من التطور العلمي، بالإضافة إلى حياته السياسية وعلاقته بالقيصر.
يسلط الكتاب الضوء على تأثير أسرة فيبر في تشكيل شخصيته، فوالدته كانت لها علاقة بالبروتستانتية الفرنسية، بينما كان والده عضوًا في البرلمانين البروسي والألماني؛ مما وفر له بيئة ثقافية وسياسية غنية. كانت علاقته بوالده متوترة، وقد توفي الأخير إثر سجال عنيف بينهما. في المقابل، كانت علاقته بوالدته أكثر توافقًا واستمرارية، رغم ما شابها من صراعات.
يكشف الكتاب عن شغف فيبر بالتفكير وتنوع اهتماماته العلمية، فهو من مؤسسي الدراسات الاجتماعية، ومحلل اقتصادي، ومنظّر سياسي، وناقد موسيقي، وأول من نظّر للعلاقة بين البروتستانتية ونشأة الرأسمالية. كان فيبر عابرًا للحدود بين التخصصات، مما جعله يساهم نوعيًا في مختلف مجالات العلم.
وعلى الرغم من مرضه الذي أصابه في سن مبكرة، فقد حقق إنجازات علمية كبيرة؛ إذ كان مقبلًا على بثِّ العلم بشغف "التفكير"، مما جعله يخوض سجالات ومعارك فكرية حادة مع مفكري عصره.
تزوج فيبر بماريانا شنيتغر، مدة ثلاثين عامًا، وله علاقات غرامية خارج الزواج. كانت ماريانا داعمة له في حياته العلمية والشخصية، وساهمت في نشر تراثه الفكري بعد وفاته. تشمل علاقاته الغرامية اليهودية إلسي يافه، وعازفة البيانو السويسرية مينا توبلر، مما يعكس جوانب إيروتيكية في شخصيته.
تطرق الكتاب إلى تأثير برلين وإرفورت على تكوين فيبر الفكري؛ فقد أثرت نشأته في إرفورت في شخصيته، بينما كانت برلين مرحلة مهمة في تكوين فكره؛ حيث تعرف على شخصيات سياسية وثقافية بارزة بفضل والده.
كما يستعرض الكتاب تجربة فيبر في جامعة هايدلبرغ، وخدمته العسكرية، وتأثير ذلك في تكوينه الجسدي والنفسي. ويتناول سجالاته السياسية مع القيصر والنظام القيصري خلال الحرب العالمية الأولى، وكتابه الاقتصاد والمجتمع الذي أسس فيه علم السوسيولوجيا الشامل.
يقيم المؤلف مقارنة بين فيبر وكارل ماركس، مبيّنًا أن فيبر ظل حاضرًا رغم عدم وجود حزب يتبنى أفكاره، على عكس ماركس الذي أسس الشيوعية. ويشير إلى أن فيبر استجاب لروح العصر وتحدى مواضعاته، مما جعله شخصية فكرية مؤثرة. ويتناول السجال النقدي حول فيبر في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما ترجمه المهاجرون الألمان من الأكاديميين الرافضين للحُكم النازي إلى الإنكليزية. كما يناقش الموقف السلبي لنقاد مدرسة فرانكفورت، مثل هربرت ماركيوزه، من كتابات فيبر.
وبناء عليه، يقدم كتاب ماكس فيبر: الشغف بالتفكير صورة شاملة لحياة فيبر وشخصيته الموسوعية، مما يجعله إضافة قيمة إلى المكتبة العربية. ويبرز الكتاب عبقرية فيبر وتأثيره المستمر في الفكر الغربي، ويسلط الضوء على الجوانب الإنسانية في حياته، من معاناته مع المرض إلى علاقاته الشخصية. وبهذا، يقدم المؤلف عملًا استقصائيًا يجمع بين الكشف عن حياة فيبر وتصوير روح العصر الذي عاش فيه، مما يجعله من أبرز علماء عصره.
